
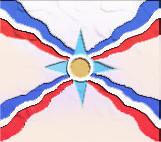
مفهوم الحرية في تصور الحركة الديمقراطية الأشورية
هرمز طيرو
أن كافة الرؤى والافكار والنظريات التي صاغتها الليبرالية قد اصبحت من الناحية النظرية صرحاً للحرية ، بحيث جعلت من حقوق الانسان الطبيعية ومن سيادة القانون والقانون الطبيعي حواجز تقف جميعها في وجه سلطة الحكم ولا يستطيع أحد من أن يتجاوزها أو يهدمها . غير أن هذا الصرح كان مجرد بناء في الهواء طلما كانت سلطة الحكم المطلقة لا تزال قائمة على أسس قديمة مثل :
1 – التوريث .
2 – السلطة الدكتاتورية .
3 – استخدام العنف .
ومن الناحية النظرية كان من السهل تأكيد قيمة الانسان المطلقة ، وأعتبار الانسان غاية وليس وسيلة وأن له حقوق طبيعية محفوظة لا يجوز تجاوزها أو إنتهاكها ، غير أن هذا التأكيد كان تأكيداً نظرياً لأنه عندما وضع تحت التجربة والأختبار وعندما برزت إلى الوجود سلطة الدولة الحديثة التي هددت الوجود الانساني في صميمه أي في حريته ، عندئذ أخذ منظرو ومفكرو الليبرالية في البحث عن ايجاد وسائل أخرى يواجهون بها هذه السلطة الجديدة التي تحاول من اهدار الحرية ، ولقد وجد فلاسفة الليبرالية هذه الوسائل في :
اولاً : تأكيد الأصل التعاقدي لسلطة الدولة .
ثانياً : المحافظة على الحقوق المقدسة المطلقة للفرد .
ثالثاً : التهديد بأنفساخ هذا العقد إذا اخلت السلطات بما التزمت به من المحافظة على هذه الحقوق .
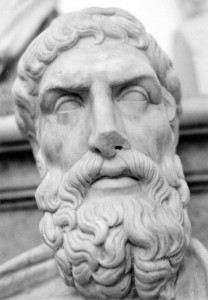
ابيقور
وواضح من هذا ، أن الفلاسفة الليبراليين قد أكملوا بهذه النظرية اخر حلقة من حلقات التضييق على السلطة المطلقة ، فقوضوا بها أساس الذاتية أو الموروثة وحولوها إلى اصحابها الشرعيين وهم افراد الشعب ، وقد عبر ( جان جاك روسو 1712 – 1778 ) عن هذا المعنى في نظريته عن " العقد الأجتماعي " التي وضعت أسس الدولة الحديثة فأوضح : أن الافراد في سبيل أنشاء السلطة السياسية قد تخلو عن جزء من حريتهم المطلقة التي كانوا يتمتعون بها في حالتهم الطبيعية ، وأما الجزء الأخير الذي احتفظوا به فأنه سيبقى أسمى من الدولة ولا تستطيع أن تتنكر له وإلا هدمت المصدر الذي نشأت منه .
وعلى العموم ، فأن فكرة قيام الدولة على أسس العقد الأجتماعي قديمة جداً ، وقد تعود جذورها التاريخية إلى الفلسفة اليونانية ، حيث يقول ( أبيقور 341 – 270 ق . م ) : بأن الانسان لم يوجد بالطبيعة وأنما نمى من تراضي افراده وتوافقهم على العيش سوية لدفع الخطر عنهم . وهنا ينبغي أن نشير أيضاً إلى أن الفيلسوف جان لوك قد اتجه وأستعاد افكار( أبيقور) في تفسيره لنشوء الدولة والقانون ، وأخذ ينشر هذه الافكار عن الحكومة المدنية سنة 1690 وذلك بعد الأحداث الدامية التي شهدتها أنكلترا أثناء الثورة الكبرى سنة 1688 .
أما الفيلسوف جان جاك روسو الذي يعتبر من أبرز منظري ومفكري " العقد الأجتماعي " وصاحب كتاب في العقد الأجتماعي الذي نشره سنة 1761 حيث أيد فيه
.jpg)
روسو
اولاً : حرية الافراد والمساواة بينهم .
ثانياً : عدم تمتع أي فرد بسلطة طبيعية على أقرانه .
ثالثاً : القوة لا تولد حقوق ثابتة لأحد على الأخرين ومهما كان مصدرها .
رابعاً : الرضا والعقد بين الناس هو مصدر الشرعية والقانون
خامساً : المجتمع يحمي نفسه بقوة افراده ، والفرد يعمل على ضمان سلامة المجتمع .
سادساً : الفرد جزء من المجتمع لكنه حر لا يطيع إلا نفسه ويمتلك كل ما يستطيع حيازته .
وعلى ضوء أراء ( روسو ) وغيره من المفكرين الذين أرسوا مفاهيم حقوق الفرد وحقوق الانسان جاء اعلان الدستور الفرنسي ( 1791 ) التي تضم المادة الأولى منه ( اعلان روسو
حقوق الانسان والمواطن الفرنسي ) : يولد الناس ويظلون احراراً ومتساوين في الحقوق ولا تقوم التمييزات الأجتماعي إلى على أساس من المنفعة العامة ، وأن الغاية من كل تجمع سياسي حفظ حقوق الانسان الطبيعية .. هذه الحقوق هي الحرية .. الملكية .. الأمن ومقاومة الطغيان .
الدولة البرجوازية وظهور المذهب الفردي
بعد أن استطاعت البرجوازية ( نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ) من السيطرة على الاوضاع الأجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية ، فقد تعرض مفهوم الحرية التي نادت به الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية إلى هزات كبيرة وتغييرات أساسية نتيجة انتشار المفاهيم الفلسفية الفردية التي ترعرعت في احضان البرجوازية حيث ارتفعت الاصوات المطالبة بالحريات الاقتصادية ، وأخذت بضرب وحجب جميع الحريات الأخرى أذا ما تعارضت مع الحرية الاقتصادية ، لأن المذهب الفردي قد انطلق من الفلسفة الفردية على أساس : أن الافراد يولدون احراراً وهم متساون في الحقوق والوجبات وأن هذه الحقوق قد اكتسبوها من ذواتهم وطبيعتهم البشرية ، وهي حقوق سابقة على قيام المجتمع ، وأن الغاية من نشؤ النظم السياسية ما هي إلا لحماية تلك الحقوق ، وأنه ليس من العدل أن تفرض على الفرد قيود لا تتناسب مع طبيعته الأنسانية ، وقد اقام المذهب الفردي فلسفته على :
1 – تقديس الفرد .
2 – أعتبار الفرد غاية بذاته وأنه قادر على تحقيق هذه الغاية بمفرده .
3 – الفرد يستطيع أن يحدد اتجاهاته المادية والفكرية لأنه بالأساس يعلو على الجماعة .
ويبدو واضحاً أن الفلسفة الفردية التي هي فلسفة متميزة للدولة البرجوازية قد انطلقت في مفهومها إلى العلاقة بين الفرد والدولة من نظرية ( الحقوق الطبيعية ) ونظرية ( العقد الأجتماعي ) حيث ذهبت في تحليلها إلى قيام الجماعات السياسية من أن للافراد حقوقاً طبيعية تسبق قيام الجماعة ، وأنهم عندما وافقوا على الانتقال من المجتمع البدائي إلى الحياة الأجتماعية فأنهم قد تنازلوا عن جزء الضروري من حقوقهم وذلك لغرض إقامة المجتمع الجديد . لذلك فأن عل السلطة السياسية حماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، وعكس ذلك فإن السلطة السياسية تفقد شرعيتها وأساسها ومبرر وجودها .
الحرية في تصور الماركسي
في نهايات القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين دخل مفهوم الحرية في ضوء النظرية الليبرالية بأزمة حادة وذلك نتيجة التحولات الفكرية السريعة وتطورات الاقتصادية والأجتماعية والثقافية ، حيث عجزت مفاهيم الحرية التقليدية عن احتواء هذه التحولات والتطورات ، فأصبحت بذلك غير ملائمة ومتخلفة بعض الشيء عن روح العصر ، وأستجابة لتلك الظروف التي احاطت بالمجتمعات العالمية ، أخذت الافكار التقدمية ( الأشتراكية العلمية ) طريقها بين صفوف المثقفين والعمال والفلاحين والطبقات الأجتماعية الفقيرة ، لأنها كانت تعبر عن همومها ومصالحها الاقتصادية والسياسية ، ومن ابرز هذه الافكار هي ( النظرية الماركسية ) التي ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر والتي حملت توقعات وتنبوأت ( كارل ماركس 1818 - 1883 ) و ( أنجلز 1820- 1895 )
.png)
.jpg)
.jpg)
ماركس انجلز لينين
وذلك بصدد قيام الثورة الأشتراكية في الدول الصناعية المتقدمة كأنكلترا وألمانيا ، غير أن هذه التوقعات والتنبوأت لم تتحقق في هذه الدول ، بل تحققت ووجدت طريقها للتطبيق الفعلي في روسيا القيصرية وذلك بعد انتصار الثورة الروسية في اكتوبر سنة ( 1917 ) التي قادها الحزب الشيوعي الروسي بقيادة ( فلاديمر إيليش لينين 1870 – 1924) عبر التغيير والتكييف الذي قام به لينين للماركسية من أجل أن تتلأم وظروف روسيا ، وعلى هذا الأساس اطلق عليها ( الماركسية اللينينية ) .
ومن هنا نستخلص ونقول بأن الفكر الماركسي قد جاء كرد فعل على الافكار الفردية البرجوازية التي تعطي للفرد الاهمية القصوى وتهمل المجتمع .
.jpg)
الثورة الروسية
نشأة الحرية .. فهم طبقي لتاريخ الحرية
لقد وضعت الماركسية تصنيفاً لتاريخ البشرية ، تاريخ ما قبل الشيوعية وهو التاريخ الذي بدأ طبقياً وينتهي بأنتهاء أو زوال الطبقات ، وبهذه الرؤية تصبح الحرية هي حرية الطبقة المتحكمة ، وهي على حد تقديرها تاريخ تفتقد ساحته للحرية ، وبتصورها ايضاً أن تاريخ البشرية سوف يمتلك الحرية عند دخوله مرحلة الشيوعية . وفي ضوء هذا التصور نستطيع أن نقول بأن قضية الحرية في كافة محطات التاريخ الأنساني حسب التصور الماركسي هي قضية مؤجلة .
اذن أن الماركسية تخضع الحريات كافة لتفسير اقتصادي أي بتعبير أخر ( ربط الحرية بالصراع الطبقي ربطاً تاماً ) سواء في نشأة الحرية أو في مضمونها ، لذا فالماركسيين يرون أن الحرية لم تكن في تطبيقها معنى مجرد ابداً ، وأن كانت قد بدأت من فكرة المساواة ، غير أن هذه كانت في اصلها فكرة سياسية . ولقد قرر ماركس وأنجلز : أن المساواة في المركز السياسي بين الرجل الحر والعبد أو بين المواطن الروماني والأنسان الخاضع لسيطرة الرومان كانت تعد فكرة غير معقولة عند القدامى ، لذا جاءت ولأول مرة وبصورة بدائية المطالبة بالحقوق والحريات المدنية ، ومن هنا نرى في القرنين الحادي والثاني عشر قد ولدت حركة قوامها ازدهار( التجارة والصناعة ) في المدن للحصول على الحقوق الأجتماعية بطريقتين :
1 – الاتفاق مع سادة الاقطاع .
2 – أستخدام القوة المسلحة للحصول على الحقوق المدنية .
ولقد كان المواطنون في ذلك الوقت مقيدين بمطالب تتلأم مع مصالح الاقطاع الكبرى وتقيد قوة الانتاج الجديدة ( التي ولدتها الثورة الصناعية ) من اجراء عمليات التغيير والأبداع لأنها كانت تفرض على القوى المنتجة قيود وكما يلي :
اولاً : القيد القانوني ( فرض الضرائب على انتقال السلع من اقطاعية إلى اقطاعية أخرى ) .
ثانياً : القيد السياسي ( انقسام الدولة إلى عدة اقطاعيات مع استغلال كل منها اقتصادياً ومالياً ).
ثالثاً : القيد الاقتصادي ( نظام الاقنان وربط الفلاحين بالأرض ) عند شراء وبيع الأراضي .
وفي هذا السياق كان لا بد من ثورة تعصف بهذه القيود كلها ، وقد كانت الثورة الفرنسية بداية النهاية لذلك العهد ، حيث أتخذت الثورة نتيجة انتصارها مظاهر مختلفة أهمها :
اولاً : في المجال القانوني ( ضمنت الثورة مبادىء الحرية والمساواة ) .
ثانياً : في المجال السياسي ( قامت الدولة الموحدة ) .
ثالثاً : في المجال الاقتصادي ( تحرر الفلاحون من نظام الاقنان وتحرر العمال من نظم النقابات الحرفية ) .
.jpg)
مؤسسي الحركة الديمقراطية الاشورية
خصائص الحرية في تصور الماركسية
في مفهوم الفلسفة الماركسية فأن للحرية عدة خصائص متنوعة تميزها عن الفلسفات الأخرى ، وسوف نحاول ادناه بيان اهم هذه الخصائص وكما يلي :
اولاً : لا تعتبر الماركسية الحرية على أنها معنى مجرد أو خالد يصلح لكل زمان ومكان ، وانما أعتبرته معنى متطور مرتبط بالنظام السياسي والأجتماعي ، لذا فأن الحرية في النظام العبودي غيره في النظام الاقطاعي وغيره في النظام الرأسمالي وغيره في النظام الشيوعي ، حيث أن الخط البياني في هذا المحطات في نظر الماركسية ينتقل صاعداً نحو التقدم المحتوم ، ففي كل محطة أو في كل مرحلة من هذه المراحل تتخذ الحرية معنى أكثر اتساعاً وتفوق سابقتها ، غير أن الحرية الحقيقية لا تتحقق في تصور الماركسية إلا في النظام الشيوعي .
ثانياً : لقد ربطت الماركسية بين انقسام المجتمع وقيام الدولة ، لأن الدولة لا تقوم إلا نتيجة انقسام المجتمع إلى طبقات ، كذلك ربطت الماركسية بين قيام الدولة وقيام الحرية ، حيث عدت الحرية متعارضة مع بقاء الدولة ، فلا تقوم الدولة كاملة إل اذا كفت الدولة عن الوجود .
ثالثاً : أن الماركسية لا تعارض قيام السلطة بصفة مطلقة ، وأنما هي تنفي وتعارض السلطة المنبعثة من سيطرة اقتصادية استغلالية فهي لا ترى أي حرج في أن تفرض الحرية على المجتمع بالقوة وبالاكراه ، لأن هذا الاكراه سوف لن يضر احداً طالما أنه سيؤدي في النهاية إلى تحقيق الحرية .
الحرية : بين الحتمية والضرورة
لقد جاء فهم الماركسي للحرية مرتبطاً بمفهومين هما .
1 – الحتمية .
2 – الضرورة .
وأن محاولة الربط الجدلي بينهما لم يكن من الناحية النظرية والعملية فقط ، بل من الناحية السياسية ايضاً ، فالمعرفة لا وجود لها إلا أذا سلمنا بنظرية السببية التي تكشف في مفهوم الماركسية عن قانون تطور المجتمع كما أن مقولة ( الحرية ) تكشف عن الدور الإيجابي الفاعل للبروليتاريا في التطور والقضاء على القديم ( الرأسمالي) وبناء المجتمع الجديد ( الشيوعي ) . كذلك فأن الماركسية قد اعترفت بأن : الضرورة والحتمية تسيطران على الطبيعة وعلى المجتمع وعلى التطور الكوني في ابسط التفاصيل ، وقد ربطت بين الضرورى والصدفة ، إلا أنها رفضت كل مظهر من مظاهر اللاحتمية وربطتها بالعوامل السببية ربطاً شبه حتمي .
الخاتمة
بعد عرض جميع مفاهيم الحرية في تصور ( الحركة الديمقراطية الأشورية ) و ( الفهم الليبرالي والماركسي ) نلاحظ إن مفهوم الحرية لدى الحركة – زوعا لم يعد مقتصراً على مفهوم التحرر ، بل اصبح مفهوم الحرية كما عبر عنه مؤسسو الحركة الديمقراطية الأشورية ( يوسف توما ، يوبرت بنيامين ، يوخنا أيشو ، نينوس بثيو ، يونادم كنا ، يوسف بطرس ) بالتعريف التالي : أن الحرية هي وعي لجملة العوامل التي تسبب الضياع لمجتمعنا والتي تحول الامة الكلدوأشورية دون سيطرتها على ظروفها ومن سيطرة نضال أمتنا على تحقيق اهدافها أيضاً. تلك الاهداف التي تتعدى اذن هدف ( التحرر) على الصعيدين الفردي والجماعي إلى ( التحرير) وتحقيق عوامل النهضة ، لأن شعبنا لا يعاني من التهميش والقتل والتشريد والتهجير فقط ، بل يعاني ايضاً من سلب الأرض وسلب الوجود والحقوق وطمس الهوية القومية ، وهذه الأشياء قلما عرفتها الأنسانية في تاريخها المعاصر، والمحاولة كانت نفسها في حكاري وطور عابدين وأورميا .. الخ .
اذن ، فالحرية لدى الحركة تعني :
اولاً : وعي الضرورة ، ونقصد به معرفة قوانين التطور الأجتماعي وقوانين الطبيعة وأمكانية استخدامهما بصورة صحيحة لتحقيق غايات محددة وأعتبار وعي الضرورة ماهية الحرية بل اعتبارها الشرط اللازم للأنسان للتأثير في تغيير أوضاعه السياسية والأجتماعية .
ثانياً : ربط الحرية بالإرادة ، أي القدرة على اتخاذ القرارات بعد معرفة الأسباب .
ثالثاً : الحرية لدى الحركة – زوعا لها مفهوم مشروط بظروف الواقع ( كما ذكرنا في الجزء الأول من مقالنا ) وحريتنا لا تتجزأ ولها خصوصية متميزة تتوقف على العمل ( الوطني ) وليس على العمل ( القومي ) فقط ، وهي عملية جدلية معقدة يأخذ فيها التداخل بين( الموضوعية) وبين( الذاتية )
شكل تفاعل ديالكتيكي متبادل التأثير .
رابعاً : مفهوم الحرية لدى الحركة يرتبط بالوعي الثقافي العام ويتأسس على الإرادة الحرة واستقلالية القرار ، وليس بشعارات ترفعها مجموعات مدفوعة ورموز قد تكون اجتماعية أو ثقافية وحتى دينية مدفوعة من جهات لها اغراضها واهدافها المرسومة .
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||