
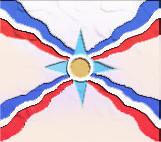
الديمقراطية بين الترويج والقناعة
لويس اقليمس
الديمقراطية، هذه الكلمة البراقة والفضفاضة، كم جلبت من منافع وفوائد لشعوب عرفت قيمتها وقدّرت لها ممارستها السليمة، لكن بالمقابل جلبت – عند إساءة فهمها - ويلات ومآس على شعوب كثيرة، أقلّ ما يمكن القول عنها إنها ابتُليت باقتحامها لمعاقل العرف القبلي والعشائري والديني الراكدة التي درجت على إثبات نفسها بالسلطنة والقهر والنهي تاركة وراءها كل محاولة إقناع وتخاطب. لكنّ الرياح الجديدة التي هبّت بفعل ما يسميه البعض منهم "البدعة" الجديدة، جاءت لتزيد من وطأة التحدّيات التي تواجهها أصلاً شعوب هذه البلدان الرازحة تحت الظلم والطغيان، ظلم يدّعونه من السماء ويسوده قوم من دون آخرين، ومعه طغيان قوى خارجية طامعة في خيرات وسذاجة هذه الشعوب التي أبقيت على الهامش مغمضة العيون.
قد لا نختلف أن الديمقراطية الحقيقية هي النخاع الشافي والساند لقوام الدول والشعوب حينما تحفظ وتصون حقوق الأفراد والمجتمعات والدول. بل هي في نظر الكثيرين ذلك النسغ الذي يؤمّنُ لقوام البشرية حقوقََها ويعزّز من ديمومتها ويشفع لها حين مرضها الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، فيتعكّز عليها من يدرك فاعليتَها ويفهم مساراتها ويطبّق ممارساتها في الحياة اليومية دون مغالاة أو شطط أو حيدٍ من مبادئها لاسيّما حين تتعدّد تفسيراتها لدى بعض مدّعيها أو ناشريها أو المطالبين بها. ومصطلح الديمقراطية مكوّن من كلمتين يونانيّتين (ديموس) وتعني الشعب، و (كراتوس) أي السلطة. ومعناها أن الشعب يتولى الحكم بنفسه، أي أنه هو مصدر السلطات. ولتسهيل هذه العملية، جرى تمثيلُُه بأشخاص يتمُّ انتخابهم بطريقة الاقتراع لتولّي الحكم لفترة زمنية تحددها الأحكام والقوانين المرعية في البلد أو المنطقة وهؤلاء يكونون خاضعين لمراقبة الشعب في أدائهم. أي أن الحكومة التي يشكلها هؤلاء المنتخَبون بموجب النظام الديمقراطي تكون مسؤولة أمام ممثلي الشعب ولهم الحق في إقصائها في حالة عدم إيفائها بالالتزامات الملقاة على عاتقها وخيانتها لثقة الشعب فيها. ولعلَّ أهمَّ بند في توفر قسط وافر من الديمقراطية، وجود الأرضية الصحيحة لتقبلها والتفاعل مع أسبابها ونتائجها على حدٍّ سواء من أجل أن تعطي ثمارها الصحيحة. ومن ذلك نستطيع أن نقدّر أن حسن سير الديمقراطية في بلدٍ ما أو مجتمعٍ عندما يتصلُ ذلك باحترام الحريات الأساسية ومنها حرية الفكر والعقيدة والدين والثقافة والتعليم والرأي والتنقل من التي خُلق من أجلها الكائن البشري حراً ليعيش حياةً كريمةً بموجب الأعراف والشرائع والقوانين الدولية والإنسانية. وهناك عددٌ من أنواع الديمقراطيات المعتمدة في أنظمة الحكم المختلفة في العالم تبَعاً للظروف التي تعيش فيها شعوبها ووفقا لفهمها وتنشئتها و خضوعهاً لتفسيرات متباينة غالباً ما تمتزج فيها الرؤية ا الفكرية والعقائدية والثقافية والمجتمعية وحتى المذهبية والعشائرية.
أدلجة الديمقراطية في الفكر الغربي
كل الأنظار تتجه اليوم نحو الغرب المتمدّن، جنّة عدن لدى الكثيرين! هذا هو الرأي السائد لدى أوساط المثقفين والعديد من المتعلمين في كون الغرب بلداً للديمقراطية والحرية الحقيقية وهو بهاتين الميزتين يكفل للفرد والمجتمع حياة حرةً كريمة تليق بالكائن البشري. هذا ما نعتقدهُ جميعا، ولا خلاف عليه. لكن ما يغيب عن فكر العديدين أيضاً أن هذه الديمقراطية قد حادت هي الأخرى عن مسارها فأفرغت من محتواها الحقيقي بحسب أهواء وتيارات كيانات أرادت تطويعها لأغراضها ووفق حاجاتها. وبذلك تكون قد فقدت هويتها في أن تكون السند النافع والنسغ الناجع لشعوب وأمم آمنت بفاعليتها في هذه البلدان المتحضرة وتطلّعت لها غيرها حسداً وتمنّتها لو زارت أوطانها ومجتمعاتها. هكذا إذن، خضعت وتخضع هذه الديمقراطية لعمليات قيصرية وإجهاضات بعد تغليفها بأيديولوجيات مُقَنّعة حتى لو كانت على تناقض مع واقع حال شعوبها أو مناطقيتها.
والسؤال اليوم، كيف يمكن تفقّّد نوعية هذه الميزة في عالم المتناقضات الصارخة وتمييز الغث من السمين في أشكال هذه الديمقراطيات؟ أنظروا ماذا جلبت أميركا من ديمقراطيتها المصدَّرة إلى شعوب العالم النامي الغافي على صهيل الخيل ونقيق الضفادع ومواء الخرفان. ومثلها ما يصدّره الغرب الأوربي عموماً إلى آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية المغلوبة على أمرها. كأني بها تنفّذُ روزنامة مدروسة الجوانب لتُفرض على مثل هذه الشعوب التي تستسيغ كلَّ جديد قادم من الغرب كأنه بلسمٌ شافٍ وشهدٌ ما غيرُه نسغٌ لحياتها وتطورها ونمائها. وإذا كانت هذه الديمقراطية قد انتقلت في نظر الغرب من طور كونها قضيةً قومية "بمفهوم الأمة" لتصبح معياراً عالمياً، فإنها تكون قد خرجت من فعل كونها هدفاً رضائياً حتى في أوساط الغرب نفسه، بسبب ما أحاطها من سذاجة ورياء في أحيان كثيرة حين انجرارها إلى غير أهدافها المرسومة. قد تكون ماهيّة الديمقراطية المطبقة في الغرب عموماً تلتقي من حيث الجوهر على أسس ومعايير دولية تصلح أن تسري في غيرها من البلدان لاسيّما ما يتعلّق بإيفائها بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان التي تستوجب تطبيقات مماثلة، لكنها من حيث الشكل قد تختلف وتختلف معها التطبيقات والتفسيرات في تفاصيل الدبلوماسية المتبعة و في الأدوات ومنها اللجوء إلى القوة حين اقتضاء الأمر وفي الشؤون الدولية المختلفة أيضاً بحسب المصالح والأغراض وما يلفُّ هذه من نوايا حتى لو طالت مسألة حقوق الإنسان.
في ضوء هذه الأفكار المتحالفة حيناً والمتناقضة في غيرها بين الغرب الأوربي بخاصة والأميركي الضاغط بضرورة " دمقرطة " العالم بالعودة إلى استخدام "عصا الطاعة" التي لا بدّ منها في نظر الأخيرة، يكون العالم النامي قد صغَرَ لها كلٌّ وفق سياقات الزمان والمكان دون أن يكون له خيار تجاوزها. وإذا كانت قلاع الحرية التي بنتها أوربا والغربُ عموماً، كما تبدو للعيان، هي التي تجذبُ اليوم أفواجاً غير معرَّفةٍ من المهاجرين، سراً أو طلباً للجوء فيها، فإن هؤلاء سيجدون نفسَهم ذات صباحٍ واقعين في وهم الأحلام وسوء التقدير لقرارهم تركَ الأوطان بتأثير الدعاية ووسائل النشر والدور الكبير الذي تتركه آثار المسلسلات والأفلام ومختلف وسائل الاتصال الإلكترونية الحديثة التي تصدّرها لهم دون رحمة. لكن الطامة الكبرى في "معظم" وليس "كلّ" هؤلاء القادمين الجدد، عشاق الديمقراطية الغربية، من دول العالم النامي ولاسيّما الآسيوية منها أنهم لا يستطيعون الخروج من شرنقتهم الشرقية، بل يبقون أسراها في كلّ شيء إلاّ في التباهي وتمنّي النفس بإقناع المقابل أنهم وجدوا ضالَّتَهم المتمثلة أصلاً بعددٍ من المظاهر الخارجية في الحياة اليومية.فمطالب الحياة التعجيزية التي يكبّلهم فيها منذ وطأته أقدامهم تجعلهم عبيداً عليهم دفع فواتيرهم الطويلة وغير المنتهية بسبب عجز معظمهم من العيش كرامتهم الإنسانية كما ينبغي إلى جانب فقدهم تواصلهم مع حياةٍ اجتماعية طبيعية وسط عوائلهم بسبب لهاثهم وراء رزق هزيل في غالب الأحيان. هذا هو الطابع العام للأوهام التي تقدمها بلدان الديمقراطية للقادمين الجدد بحسب أيديولوجية ساستها التي تقتضي التضحية بأمور كثيرة لأجل لقمة العيش والتمتع بالانبهارات التي يقدمها يومياً.
الديمقراطية في السياسة الدولية
منذ أن أصبح العالم قريةً صغيرة بفعل العولمة وتسيّد سياسة القطب الواحد على مغالق الحياة ومنافذها، تحددت معها معاني الديمقراطية. فقد انصبّت جهود الإدارة الأميركية على عهد الرئيس الحالي جورج بوش الابن على ما أسماه ب" أجندة الحرية" و "الترويج للديمقراطية" وأكسبها إنصاتاً عالمياً لدى الكثيرين، دولاً وشعوباً وأفراداً. إن هذا البرنامج الذي جاء ليؤكّد سمة التزامن بين ما يراه البعض من قطيعة وتواصل في آنٍ معاً بين سياسات الأمس واليوم يعيدنا إلى الحيثيات التي انبثقت منها هذه الضرورة في مراجعة الأحداث التي شهدها القرن العشرين بعد الحرب العالمية الثانية وما تلاها من أيام الحرب الباردة بين قطبين متناقضين في كل شيء وإلى سقوط آخر عهد الدكتاتوريات الغربية التي طبعت حقبة السبعينيات ومنه بروز موجة ثالثة من أنواع الديمقراطية (بحسب الكاتب صامويل هانتنغتون – من جامعة أوكلاهوما) وما تلاها من سقوط الشيوعية واندثار الكتلة السوفيتية في نهاية القرن المنصرم. تلك كانت و مات زال الفكرة السائدة في تطويع العالم وإقناعه أو إقحامه في مشروع "الدمقرطة" العتيد ومن ثمّ في عدم التعامل مع من يرفض مثل هذا التوجه من حيث المبدأ في الأقلّ.
بالتأكيد، لم تعد مسألة الديمقراطية مثار شكٍّ في الغرب الذي تبناها سبيلاً لبناء الحريات ورفاهية الشعوب، أفراداً ومجتمعاتٍ، وتنمية الاقتصاديات وتطوير وسائل الحياة المختلفة. بل إنه رأى فيها ما لم تستطع بقية الشعوب النامية تحديده لأولوياتٍ تتلاقى مع المصالح العليا لأممهم ومناطقهم. وهذا ما يفسّره رهان السلام والاستقرار والتوازن المجتمعي لدى الشعوب التي سلكت درب الديمقراطية وأصبحت بمأمن من الحروب والفتن داخل بلدانها وأعادت ترتيب بيتها الداخلي باستخدام الحكمة والعقل والفكر الناضج. ولعلَّ أفضل مثالٍ على ذلك أوربا التي ودّعت حالة الصراع المميت الذي كانت تعيش فيه واستبدلته باتحاد فعليٍّ بعدما اتصفت بسمة القتل والعنف لسنوات وقرون طوال أنهكت قواها لحين حطّت الحرب العالمية الثانية أوزارها. ومن ثمّ انتقلت وفق سياسة دولية للتبشير بالمبادئ الديمقراطية في غيرها من بلدان العالم التي ما تزال ترزح تحت وطأة الظلم والتخلف والتعسف من قادة وسلاطين رافضين أيَّ فكر جديد خوفاًً على كراسيهم وامتيازاتهم، دينية كانت أم مدنية أم قبليية،من يقظة شعوبهم المغلوبة التي اعتادت دفع هذه
من جهة أخرى، يبدو للبعض أن الترويج لهدف الديمقراطية يقضي باستخدامها وسيلةً في الصراع ضدّ ما نسميه اليوم بالإرهاب. فمن حيث الشكل والفعل يبدوان أمرين متناقضين كلياً وهما فعلياً لا يلتقيان لا في المضمون ولا في الشكل. فحيث الإرهاب لا يمكن أن تنمو الحرية أو تعيش الديمقراطية ذلك أن منظّريه متشبّثون بأجندة مرسومة السبل والوسائل ومعلومة الأسباب والأهداف، وأقلُّ ما يُقال عنها أنها لا ترضى لا من قريبٍ ولا من بعيدٍ بأية مظاهرَ تعكّر عليها صفو سطوتها وتحكّّمها في عقول وضمائر تابعيها. ومن يجرؤ على فعل تحدّيها وكسر هذا الطوق يكون عرضة للتصفية والمماحكة وإيقاع الحدّ عليه في أسوأ الظروف. تلكم كانت استراتيجية الحكومات الشمولية والأنظمة الشيوعية في عهود فرض سلطاتها وما تزال أنظمة كثيرة في الدول النامية لاسيّما الثيوقراطية منهاً، تسير وفق ذات النهج. كما شهد العالم بزوغ فاشية جديدة تمثلت بما يسمّه البعض ب "الإسلام الفاشيّ" مؤخراً و الذي يُعتقدُ حلولُه محلّ الأنظمة الشمولية السابقة ليطفح كيلُهُ ويسبح ضدّ التيار الإنساني بل ضدّ التيار المعتدل للإسلام نفسه الذي يسعى لتحكيم العقل والتناغم في تفسيراته مع العصرنة بالرجوع ببساطة إلى الكتب السماوية والغرف من منابعها السمحاوية والرحمانية. ولعلَّ من الوسائل المتاحة على إرساء ومضاتٍ من الديمقراطية تكمن في القبول بالآخر والاعتراف برأي الشعوب من خلال ممارسات اجتماعية متحضرة أهمها مسألة تداول السلطة من خلال ظاهرة الانتخابات الحرّة التي تُعَدُّ سمة الشعوب المتمدّنة. ولكن ينبغي الإدراك أيضاً أن الفعل الانتخابي أي السماح بإجراء انتخابات عامة ليس بالضرورة أداة وعلامة على سبر قواعد الديمقراطية التي تبقى بعيدة كلَّ البعد عن المفهوم الحقيقي لها إذا شابتها لعبة الأيادي القذرة. فديمقراطية إسميّة تحت هذا العنوان إنما هي نوع من الضحك على الذقون، والبقاءُ على حكومات وأنظمة شمولية فيها قسطٌٌ من الحرية لأفضلُ من فرض ديمقراطياتٍ همايونية وغير حرّة.
تصدير الديمقراطية
ممّا لا شكَّ فيه أن أحداث أيلول 2001، و بهولِ ما صنعته،ُ كانت الحافز الأكبر للعديد من دول العالم وأوّلها الإدارة الأمريكية، للعمل على تسارع عملية "دمقرطة" الأنظمة التي لا تقبلُ بغيرها شريكاً آدمياً في الحياة والحكم وهي ما تزال أيضاً ترفض التعامل مع شعوبها وفق منظور الحريات الذي تقرّه المعاهدات والمواثيق الدولية في سعيها لضمان حرية الفرد والمجتمعات بغضّ النظر عن الدين أو اللغة أو العرق أو المذهب أو الجنس وما شاكلها، إيماناً بأن الجميع سواسية في القانون وأمام القضاء وفي الحريات العامة والخاصة. من الجدير ذكره، أن خطوات أخرى كانت قد سبقتها على ذات المنوال في حقب مختلفة من حكم الحزبين التقليديين فيها منذ نشأتها. ولكنها أيقنت وفق منظورها القومي في هذه المأساة أن النقص أو غياب الديمقراطية في العالم بات يشكل حقاًّ مصدراً حقيقيا للتهديد العالمي ومن ثمَّ، فقد آن الأوان للترويج لها وفرضها أو إحلالها بشتى الوسائل والأدوات المتاحة. ومثلها كان لأوربا قسط وافرٌ من هذا الرصيد مع تطور الأحداث فيها والتغييرات التي حملها اتحادها فيما بعد ولكن بوسائل أكثر قرباً و توافقاً مع المعايير الدولية واقترانها مع تطوير المؤسسات المتعددة في هذا الاتجاه لاسيّما ما يتعلق منها في مجال العدالة الاجتماعية والخدمات العامة والتوجه نحو اللاّمركزية بموجب معاهدة كوبنهاغن الموقعة عام 1993. حيث يعتقد الاتحاد الأوربي، دولاً وشعوباً، أن من مصلحته هو الآخر أن تستوعب الديمقراطية أنظمةً أخرى تفتقرُ إليها. ولعلَّ هذا ما يميّزها عن أميركا في اقتران فعلها بما تؤمنه في مسألة احترام حقوق الإنسان وليس في نشر الديمقراطية على عواهنها. وهذه الأخيرة تستخدم من الوسائل المتاحة ما يجعلها حريصة على تحقيق هدفها من خلال الحوار ومراقبة الانتخابات ورصد الانتهاكات ودعم المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان والنقابات والجمعيات. وقد تختلف الأساليب أيضاً من دولة أوربية إلى أخرى في تحقيق هذه الغاية ولكن يبقى الهدف واضحاً لا لبسَ فيه. ففرنسا ترى مثلاً، أنها تحبّذ التعامل مع الأنظمة غير الديمقراطية كلاً على حدة، أي حالة بحالة من خلال التأكيد على تنمية الجانب الاقتصادي والاجتماعي وعدم فرض نظام موحد حرصاً منها للحفاظ على مصالحها أولاً واعتقاداً أيضاً بحماية أصدقائها التقليديين كلاً حسب ظروفه. وهذا ما يميزها وأوربا معها عن أميركا في اتخاذ لغة الحوار وتجربة الوسائل المتعددة وإطالة الصبر على المارقين عن الديمقراطية التي ترتئيها وعدم اللجوء إلى استخدام القوة إلاّ في الحالات التي لا مندوحة من طول الأناة معها كما هي الحال المتأزمة حيال الملف النووي الإيراني بسبب تعنّت هذا الأخير في حين رضخ الكوريون الشماليون إلى صوت العقل بعد استنزاف كافة حيلهم. أب أن أوربا عموماً لا تؤمنُ باستخدام القوة في تصدير الديمقراطية كما هي الحال مع أميركا ولها في ذلك من أسباب ما يحملها لعدم تقبّل هذا المبدأ. فهي ترى في ذلك التوجه خطورة عند جهل أو تجاهل الجهة المصدّرة لهذا المفهوم لطبيعة الوضع الداخلي للنظام المقصود تغييرُهُ ضمن المحيط الإقليمي والدولي الذي يراهن عليه كما حصل للتدخل الأمريكي في الفيلبين وأميركا اللاتينية وفيتنام وأخيراً العراق ومن يدري بعد. وهنا يمكن ملاحظة الفارق في التحرك في هذا المجال بين كلٍّ من أميركا وأوربا. ففي حين تختلف التحركات الأميركية بانطلاقها من القاعدة أي من الأسفل بطريقة لامركزية وعبر مؤسسات المجتمع المدني وفق أدواتها المتاحة و ثقافةٍ سياسيةٍ خاصة بها تساعدها في تكوين استراتيجيتها القاعدية، تسعى أوربا تماماً بعكسها منطلقةً من فوق أي باستخدام الوسائل المؤسساتية في الدولة المقصودة. وهذا ما يفسر اختلاف الرؤية حول سقوط الاتحاد السوفيتي السابق مثلاً. ففي حين ترى الولايات المتحدة الأميركية في مساهمة المجتمع المدني ومعه السوق في رصد أخطاء القيادة آنذاك وتحرّكها بوسائلها الخاصة في تآكل النظام الشمولي، يعتقد الأوربيون عكس ذلك في أن ما آل إليه النظام السابق مردُّهُ الدور الذي لعبه قادة تلك الدول ومختلف المبادرات التي أسهمت بطريقة أو بأخرى في انهياره. وما كان سقوط جدار برلين وفق هذه الأخيرة والذي يُعدُّ سقوطاً قاسياً للجدار الحديدي في العالم، سوى بداية حقبة جديدة تعاقبت عليها تجارب ومحاولات لمساعدة الدول التي لم تكن تعترف بالديمقراطية للانخراط في هذه العملية من خلال مؤسسات سياسية واقتصادية مستقرة بعض الشيء. وهذا ما يشير بوضوح إلى الرؤية التي تغذيها التجربة الأوربية باهتمامها المباشر بسلطة الدولة ومؤسساتها العامة. إن هذه النموذجية المختلفة في التعاطي مع هذا الشأن الحساس جدّا في كلتا الفكرتين المختلفتين قد وجدها البعض تتلاقى في غاياتها وتتكامل من حيث المضمون مع الاعتراف باختلاف الوسائل طبعاً. إلاّ أن ما يثير الشكّ في التدخل الأميركي في الشرق الأوسط والمنطقة الآسيوية عموما وفي نواياه المضمَرَة قد توضحََّ مع احتلال العراق بخاصة بحجة التخلص من بلد يحكمه نظام دكتاتوري حسب مفهومهم، كما نفى عن الغازي المحتلّ هدفَهُ المعلَن. واليوم يشهد العالم نوعاً من التقارب في وجهات النظر حيال هذه النموذجية فيما يخصُّ الوضع الراهن في العراق.
حََوٌََلُ فكريٌ في قارة آسيا إزاء الديمقراطية
يبدو للعيان أن أوربا تسعى أكثر من غيرها إلى خلق آلية من التعاون بين مختلف مؤسساتها و منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان تجاه بلدان العالم المختلفة التي تفتقر حقاً إلى الديمقراطية في أنظمة حكمها ولاسيّما الأسيوية منها أي عموم الشرق الآسيوي بالاعتماد على استراتيجية واضحة واستخدام أدوات فاعلة لاسيّما التمويلية منها بدل العصا الغليظة التي تعتمدها أميركا من أجل تحقيق الهدف. إلاّ أن عدداً كبيراً من البلدان الأسيوية التي طالها نوعٌ من التدخل الخارجي للسبب المعلَن أعلاه تحتاج إلى وقفة تأمّلية ونظرة ثاقبة في أصول تكوّنها وفي طبيعة أنظمتها وشكل اعتقاداتها. فهي في الوقت الذي تفتقدُ فيه إلى بُعد في الرؤية وإلى غيابٍ في الفكر وإلى حالاتٍ مرصودةٍ من التخلف والجهل والفقر المدقع في صفوف شعوب الكثير منها، تكادُ بل بقيت في معظمها أسيرةَ تجاذبات كثيرة داخل مجتمعاتها المتنوعة إثنياً وعرقياً ودينياً ومذهبياً وعشائرياً وأيديولوجياً بل وحتى داخل الطائفة الواحدة والحزب الواحد. كما أنها لم تستطع التخلص من عُقَدِها، وما أكثرها، ومنها بخاصة عقدة "الغرب المسيحي"، التي جاءت على شاكلة العقدة المنهجية العربية والإسلامية من إسرائيل، والتي باتت ترى في الدول الغربية ومنها بطبيعة الحال أميركا، الشيطان الأكبر والطوطم الذي ينبغي اقتلاعُه ومحاربتُه بشتى الوسائل. إن دلَّ هذا على شيء، فإنّما يشيرُ إلى قصر نظر وجهل أو تجاهل للحقائق. فالغرب اليوم، يعتمدُ في تقويم أنظمته الحاكمة قدراً وافياً من الوعي والاحترام إزاء جميع الشعوب ومختلف المجتمعات التي تعيشُ وتتعايشُ على أراضيه بحكم عمل هذه الأنظمة بنظامٍ صارمٍ للعلمنة والعولمة في آنٍ معاً. وهذان الخطان المتوازيان لا يمكن تخطيهما في مجمل هذه الأنظمة الغربية، في أوربا أو أميركا، و المتهمة كَشَحاً بمعاداة السامية أحياناً وبرفض غير أعراقها على أراضيها. ولو كانت تلكم هي الحقيقة لَمَا تراكض، بجنون نحو القلاع الديمقراطية التي بنتها، الملايينُ من أبناء الشعوب المغلوبة على أمرها والرازحة تحت نير أنظمة سلطوية لا تعترف بالحريات، فردية كانت أم مجتمعية، ولا تعير أذناً للنداءات الدولية الصارخة المطالبة بحق الكائن البشري و بحق مجتمعات بأكملها قد طالتها مختلف الانتهاكات في حياتها اليومية ومنها بطبيعة الحال شعوب آسيا بلا استثناء.
أليومَ، آسيا بكافة مجتمعاتها الشرقية وبالميكانيكية التي تعتمدها في سياساتها تكادُ تغلي على سعير حروبٍ متنوعة ومتعددة، منها الداخلية ومنها الإقليمية. فهذه فلسطين تكتوي بنزاعات داخلية دموية يومية بين فصيلين متناحرين لا يعرفان كيفية العيش المشترك وتقاسمَ الشراكة السياسية في أجواء ديمقراطية معينة أُتيحت لشعبها الجريح الذي يبقى ضحية الجهل بمصالحه وأسيرَ عقدةٍ مستفحلة كان هو السبب في ضياع أرضه ووطنه في غفلة من الدهر. وهذه شبه القارة الهندية التي أوصلت قادة البلدين الجارين، الهند والباكستان إلى حافة حربٍ نووية. لكن أصول اللعبة قد انتقلت في غيرها من البلدان لتحطّ الرحال في مجتمعاتٍ متنافسة داخل الدولة الواحدة، بل داخل المجتمع الواحد عينه في أحيانٍ أخرى، كما تشير إليها حالات الاقتتال الداخلي المرصود بسبب التعصّب القبلي أو القومي أو الديني أو الطائفي أو المذهبي أو الأيديولوجي في كلٍّ من فيتنام وإندونيسيا والفيلبين ومتخذةً مساراتٍ واتجاهاتٍ أكثر خطورة وأشدَّ تعقيداً لاسيّما في كلٍّ من العراق وباكستان وأفغانستان. وقد تختلف الحالة في الهند والصين اللتين تشكلان مع الجارة باكستان ما يقرب من نصف ساكني الكرة الأرضية، بل يُخشى أن يكون الخطر القادم منها أكبرَ لما تحملُه من قوة بشرية واقتصادية مهولة بدأ العالم يتنبه لها مؤخراً بشئٍ من الريبة والخوف. فالصين قد اجتاحت في اقتصادها كل التوقعات بغزوها الأسواق العالمية بلا منازع ومنها الأوربية والأمريكية لاستعدادها البشري بتلبية كل الاحتياجات مهما كانت صغيرة أم كبيرة، بسيطةً أم معقدة، علميةً أم مادية، عسكريةً أم مدنية وبالأسعار التي يرتئيها الزبون. وهذا دليلٌ واضحٌ لتصاعد الاستهلاك المادي لدى هذا البلد المترامي الأطراف. وفي الهند، هذا البلد الذي يَعُدُّ أكثر من ألفي عِرق وطائفة لم يخلُ هو الآخر من أعمال عنف وانتهاكات واعتداءات بين هذه الطوائف نفسها رغم انتهاجه سياسة أقرب ما تكون إلى العلمنة الغربية وقربه من المبادئ الديمقراطية التي تؤمن بها الدولة كنظام للحكم. ولعلَّ ما يجذب الأنظار مؤخراً، تحوّلَ الهندوس الذين يشكلون الغالبية العظمى في حربهم من أجل البنجاب مع باكستان إلى توجيه عنفهم الشرس تجاه المسيحيين مؤخراً بحسب وسائل الإعلام، وفي ذلك خطرٌ لابدَّ للناقوس أن يدقَّ إزاء ما يحصل. ربما تكون ذات الرؤية وذات النظرية في معاداة المسيحية بسبب الموقف الناقد من السياسات الغربية ورفض رؤياها المتمثل بإحلال عالم جديد وفي تفكيرها بإعادة هيكليته وفق أسس الديمقراطية المُعصرَنة التي تسعى إلى تصديرها وإقناع هذه الدول بضرورة تبنيها لمصلحة شعوبها وأنظمتها المتهالكة في بعضها. لكنها أي الهند أو غيرها من الدول والأنظمة الناقمة تكون قد وقعت في وهم مطبق إذا ما حاولت التفكير أو الأخذ باقتران سياسة الغرب بالمسيحية لأن الأخيرة دينٌ عالمي لم يكن للغرب فيه فضلٌ في انتشاره بادئ ذي بدءٍ لأنَّ أصوله خرجت من الشرق الآسيوي وما تزالُ فيه رغم حملات العنف الظالمة التي طالتهُ وما تزال بشراستها في محاولة لإخلاء المنطقة من جذوره. كما أن الغربَ لا يعيرُ للدين أهميةً في مجمل سياساته بعد فصل الدين عن السياسة وانتهاج مبدأ العلمنة في حياة شعوبه.
وإزاء ذلك، يبدو واضحاً أن هذه الشعوب الآسيوية عموماً، وبسبب غياب الفكر لدى فئات كثيرة لديها و ضيق أفق مدارك غيرها قد آثرت سبيل العنف بديلاً والعيشَ على هامش المجتمعات المتحضرة نابذةً نفسها بنفسها لعدم قدرتها على مواجهة الذات الأنا أولاً والواقع المتمدّن حولها. وهي أيضاً بقصر نظرتها إلى واقع الأحداث الكبيرة والدرامية وخلطها بين الحقيقة والوهم لم تعد تعرف ما تريد كما لا حيلة لها بتوضيح كيف تريد أن يكون ما تعرفه. وهذا ما يفسُّر استشراء مسلسل العنف الطائفي والعرقي في أوساطها وما من قوة تقهرُهُ أو تضع لهُ حدّاً. و لعلَّ آخر هذا المسلسل ما حصل في باكستان مع انقضاء العام 2007، حيث قضت "بنازير بوتو" بطلةً شجاعةً وسط همجية من لم يعرفوا حقَّ قدرِها وقيمتَها الإنسانية في سعيها لانتشال بلدها وشعبها من براثن التخلف والجهل والقهر الديني الناقص والطاغي والمتمثل بالرعاع المزروع في أرض البنغال بلا رحمة. فقد كانت كوالدها واعيةً لواقع حال شعبها المكبوت تحت ظلال الفقر والتخلّف والجهل والتشدّد الذي لا يثمرُ سوى العنف والارتداد بالأمة والبشرية جمعاء إلى الوراء. لذا جاءت هذه الجريمة لتعيد إلى الأذهان ذات النظرة التي قضت في أواسط السبعينيات على والدها "ذو الفقار علي بوتو" من قبل طغمة عسكرية متزلفة بالدين. هو ذات المسلسل إذن، والذي تكرّر في جريمة اغتيال المهاتما غاندي ومن بعده رئيسة وزراء الهند الراحلة "أنديرا غاندي" ومن بعدها ولدها " راجيف" من جهات متعصّبة لا تعرف ما تريد وكيف تريد. وهذا ما يفسّرُ بكل وضوح ارتهانَ شعوب القارة الآسيوية في ميزة الحوَلِ المجتمعي أسيراً لعقدة مستديمة إسمُها الغرب. وتشير كلُّ الدلائل إلى استمرار هذا العنف مع وجود حالة التطرف والتشدّد التي يزداد سعيرها مع الإيغال في الجهل والتخلّف ورفض عالمٍ متمدّن يطوّرهُ العلم ويكفلُه التقدم الحضاري بكل تفاصيله تقنياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وفكرياً. وبغير ذلك لن يستقيم الشرق مادام غارقاً في ردّة الماضي وعقدة الحاضر ورفض كلّ شيء جميلٍ وجديدٍ.
الخاتمة:
ممّا سبق يدرك المرءُ أن لا شيءَ غير المحبة والتآخي والثقة بين الشعوب والأمم تستطيع أن تخلق عالماً متوازناً ومتزناً معاً. كما أنه لا سبيلَ لحياة مستقرٍّةٍٍّ وآمنةٍٍ و مرفَّهَةٍ إلاّ بقبول الآخر والاعتراف به شريكاً في الحياة التي هي ملكُُ الله الخالق وحدهُ.وأنّ أية محاولة للتعدّي على الكائن البشري في أيِّ ظرفٍ أو لأيِّ سببٍ هو رفضٌ لعمل الخالق وتجاوزٌ للقوانين السماوية والوضعية وانتهاكٌ للحقوق العامة والإنسانية وتعارضٌ مع مبادئ الفكرة الديمقراطية. لذا على الدول المتقدمة أن تؤدي واجب المساعدة والأخذ بيد غيرها من الدول النامية والمتخلفة على ركب سلّّمِ التقدم الحضاري والإنساني من خلال مساعدة شعوبها في التخلص من براثن الفقر والجهل والتخلّف في كلّ أشكاله ووسائله وأدواته وحثّ قادة هذه الدول بقبول الاعتراف بمبدأ المساواة والحريات العامة بدءاً من الفردية منها وفق صيغٍ مقبولة من الديمقراطية الملائمة لشعوبهم ودولهم وفي عدم فرضها بالقوة تحت أية ذرائع. ومن هنا يأتي التمييزُ ما بين يطرحُهُ العالم المتحضّر من ديمقراطية واضحة المعالم والأسس وما بين الأوهام التي تصدّرُها بعض الدول لمثل هذه الشعوب الغارقة في عنفٍ متصلٍ بغياب الفكر حيناً وبالجهل والتخلف وقصر النظر إلى الأحداث والواقع المعاش في حين آخر. وهذا ما يجعل دول العالم الثالث ومنها ربّما الشرق الآسيوي بخاصة ألاّ يتقبلَ أية أفكارٍ جديدة ومتحضرة يراها غريبةً على واقع حياة شعوبه خوفاً من كشف المستور وضياع الزعامة السلطوية من تحت أيديهم بفعل الأفكار الجديدة التي يأتي بها مفهوم الديمقراطية التي إن مورست بموجب قواعد احترام الآخر والاعتراف به إنساناً مخلوقاً على صورة الله ومثاله لما تعثرت تلك السلطات في استمرار حكمها. ويبقى الرهان قائما ومختلفاًً في كيفية تطبيق الديمقراطية ومعايشتها يومياً من بلدٍ لآخر ومن شعبٍ لآخر ومن مجتمعٍ لآخر.
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||