
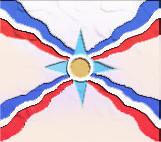
المراحل التاريخية لتطور المجتمع البشري..
المرحلة الا شتراكية
خوشابا سولاقا
لقد توقع المفكرون الاشتراكيون الرواد الاوائل للفكر الاشتراكي وفي مقدمتهم كارل ماركس بان الصراعات الموجودة في النظام الراسمالي والتناقضات السائدة فيه بين القوى الانتاجية "العاملين" ومالكي وسائل الانتاج "الراسماليين" بحكم انعدام المساواة واختلال التوازن لصالح الراسماليين، هذه العلاقة التي نتيجتها ان تزيد العاملين فقرا والراسماليين ثراءا تؤدي حتما الى حصول تمرد او ثورة عالمية عمالية على الراسماليين والقضاء على النظام الراسمالي الاستغلالي واقامة سلطة العمال في بناء النظامي الاشتراكي القائم على اساس ملكية المجتمع لوسائل الانتاج وان حصول مثل هذا التحول امر حتمي بحكم قوانين التطور التاريخي للمجتمع بحسب وجهة نظر كارل ماركس مؤسس الاشتراكية العلمية كما اطلق عليها في منظومة الدول الاشتراكية السابقة.
انطلاقا من هذه المقدمة المختصرة ممكن وباختصار شديد ان نعرف الاشتراكية والاسس العامة التي ترتكز عليها.
فالاشتراكية هي مجموعة متكاملة من المفاهيم والمناهج والتنظيمات والوسائل التي تشترك في رفض المجتمع الراسمالي القائم على اساس الملكية الفردية لوسائل الانتاج، والايمان بالارادة الثورية لاقامة مجتمع العدل والكفاية، بغية تحقيق المساواة الفعلية بين جميع الناس وبين جميع الامم.
وتتحدد اسس الاشتراكية بمعايير رئيسية هي:
اولا: الموقف من الملكية، الذي هو رفض الملكية الفردية لوسائل الانتاج والعمل على تحقيق الملكية العامة الجماعية دفعة واحدة او تدريجيا لوسائل الانتاج.
ثانيا: الموقف من التنظيم الاقتصادي، فالاشتراكية تؤمن بمبدأ تخطيط النشاط الاقتصادي تخطيطا علميا وشاملا.
ثالثا: الموقف من التنظيم الاجتماعي تؤمن الاشتراكية بمبدأ الادارة الديمقراطية للاقتصاد في اطار اوسع حرية للنقد والمبادرة الخلاقة.
رابعا: الموقف من المساواة، تؤمن الاشتراكية بحق الناس جميعا في المساواة الفعلية وتحقيق هذا الهدف بخطوات ذاتية، بما فيها مساواة المرأة بالرجل في كل شيء.
اذن الاشتراكية ترفض النظام الراسمالي القائم على الملكية الفردية واستغلال الانسان للانسان وتؤمن بالتقدم الحتمي للحياة الاجتماعية وتؤكد ارادتها الحرة الثورية في اقامة مجتمع اكثر كفاية وعدلا عن طريق الفعل الجماعي الواعي وملكية المجتمع، بغية تحقيق المساواة الاجتماعية بين الناس في كل مجالاة الحياة.
ان هذا التعريف العام والشديد العمومية لمعنى الاشتراكية لا يفي بالغرض، حيث هناك دراسات عديدة تختلف في تحديد المعنى العلمي للاشتراكية، وعند استعمال كلمة الاشتراكية يجب التفريق بين معناها كتعبير "ايديولوجي" وبين معناها عند استخدامها كمجرد علامة لجماعة تقول بالاشتراكية، وان الاشتراكية تستخدم اليوم من قبل مجموعات سياسية متباينة تختلف فيما بعضها البعض بل وتختلف حتى داخل نفسها حول اسلوب وطريقة تطبيق الاشتراكية وتفسير مضامينها الفكرية والعلمية.
وانطلاقا من هذه الزاوية، من الممكن ان نقول ان الاسس الايديولوجية العامة للاشتراكية لم تعد الان هي المحور الرئيسي للخلاف والصراع، وانما المحور الرئيسي للخلاف والصراع اصبح اليوم يدور حول اسلوب وطريقة تطبيق الاشتراكية في الحياة الاجتماعية، حيث اصبحت الوسيلة والطريقة هي المشكلة الرئيسية للعصر الاشتراكي.
والاشتراكية بوصفها ايديولوجية تتكون من ثلاثة عناصر اساسية يسبق احداها الاخر وفق نوعية الاتجاه الاشتراكي ووسائله وهذه العناصر هي:
اولا: العنصر الاقتصادي.. ان الاشتراكيين يرون ان من اهم الاسباب المحركة للمجتمعات والناس، والسبب النهائي الذي يقرر شكل العلاقات الاجتماعية هو نوع العلاقات الاقتصادية او بمعنى اخر نوعية العلاقات الانتاجية من حيث دور الربح ومدى التناسب في الدخول وفي توزيع خيرات المجتمع على افراده وكيفية التصرف في فائض القيمة المنتجة.
فجميع الاشتراكيين متفقون على الفائدة العامة وانها لا تتحقق الا بنقل ملكية وسائل الانتاج كلها او على الاقل الرئيسية منها من ملكية الافراد الى ملكية الدولة وهذا ما يسمى اقتصاديا "بتأميم وسائل الانتاج".
والاشتراكيون متفقون على السيطرة الواعية العقلية على جميع مظاهر الحياة الاقتصادية في المجتمع وهذا الامر لا يحصل الا عن طريق التنظيم العقلي المنهجي العلمي للحياة الاقتصادية ان هذا التنظيم وحده يضع المصلحة الوطنية العامة فوق كل الاعتبارات وهذا التنظيم هو مايسمى "بالتخطيط المركزي للدولة".. وكذلك فان الاشتراكيين متفقون ومجمعون على ان التاميم لوسائل الانتاج والتخطيط لا يكفيان وحدهما لتحقيق الرفاهية الحضارية لجميع المواطنين، وانما لابد ان يصحب ذلك على التوازي تغيير في اساليب الانتاج والادارة في الوحدات الاقتصادية بحيث يكون التشغيل وفقاً لادارة جماهير الشعب العامل.
ثانيا: العنصر الفلسفي... ان الاشتراكيين ينطلقون في موقفهم الفلسفي من نقطة الحكم بان المجتمعات السابقة للاشتراكية والقائمة على اساس ملكية الانسان وملكية وسائل الانتاج الفردية هي مجتمعات استغلالية وظالمة وسيئة، وكذلك ينطلقون من فكرة حتمية وامكانية الانسان ان يغير ظروفه الى ما هو افضل واكثر تحقيقا لسعادته ورضاه، وينطلقون ايضا من فكرة ان احداث الحياة الانسانية مترابطة بعضها بالبعض، ومن فكرة ان الحياة تقوم وتتطور على صراع الاضداد التي تنشأ بالضرورة عن ظروف موضوعية، وان يؤدي صراع الاضداد الى ان يتحول فيها التطور الكمي الى تغيير كيفي في العلاقة بين قطبي التناقض وبالتالي يسود الاصلح منهما وهكذا يستمر التطور الاجتماعي تصاعديا.
ثالثا: العنصر النضالي... جميع الاشتراكيين يرون ان النضال اليومي والفعل التطبيقي اليومي هو اساس وضمان التغيير الثوري الاشتراكي، من هنا فهم لا يفصلون في اي حال من الاحوال بين النظرية والتطبيق، كما يرون ان العمل النضالي يكون اكثر فعالية كلما كان اكثر تجميعا وتنظيما وكلما كان اكثر وعيا ومرونة وحركة.
وعلى هذا الاساس يدعو الاشتراكيون الى ربط جميع الوظائف الاجتماعية ببعضها البعض، وربطهما بمراكز التوجيه والوعي في المجتمع، وتتحدد ماهية هذه المراكز وفقا لنوعية الاشتراكية، فهي قد تكون الدولة، او قد تكون الحزب، او قد تكون المجالس الشعبية، او قد تكون البرلمان، او قد تكون فئات اجتماعية محددة تمارس التوجيه والتوعية بطريقة الضغط من مراكز القوى مثل الفئات البيروقراطية والتكنوقراطية وغيرها.
والاشتراكية باعتبارها وصفا لمجموعات سياسية متباينة تتكون من انواع عديدة ظهرت على طول التاريخ الانساني الحديث واهم انواع الاشتراكية المعروفة هي:
اولا: الاشتراكية الخيالية او الطوباوية... وقد ولدت هذه الاشتراكية عن صرخة ضد البؤس والشقاء والمظالم في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر وروادها الاوائل سان سيمون وشارل فورييه واوين وغيرهم من الاشتراكيين الطوباويين وكارل ماركس هو الذي اطلق على هذه الاشتراكية اسم الاشتراكية الخيالية او الطوباوية.
ثانيا: الاشتراكية العلمية.. هي الاشتراكية الناشئة عن التحليل العلمي الواعي للمجتمع ولظروفه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية على اساس شمولها وترابطها وتناقضها وتصارعها واتجاهها دائما الى نفي بعضها البعض، وتجاوز الاقل الى الافضل في خط حلزوني صاعد، وبالاعتماد على معرفة القوانين العلمية التي تحكم تطور وتقدم المجتمعات الانسانية، ويعتبر كارل ماركس هو مؤسس الاشتراكية العلمية.
ثالثا: الاشتراكية الاصلاحية.. وتطلق هذه التسمية على جميع الاتجاهات الاشتراكية غير الثورية التي تظن ان في مقدورها ان تنقل المجتمع من الراسمالية الى الاشتراكية بالطرق السلمية غير الثورية داخل اطار المجتمع والدولة الراسمالية ذاتها وذلك عن طريق المساومات والاصلاحات الجزئية وحسب متطلبات تلبية حاجات المجتمع وبشكل تدريجي وصولا الى بناء مجتمع المساواة والكفاية والعدل وتمثل الاشتراكية الديمقراطية في البلدان الراسمالية المتقدمة في اوروبا نموذجا لهذا النوع من الاشتراكية.
وقد تمكنت الاشتراكية الديمقراطية او الاشتراكية الاصلاحية في بلدان اوروبا الراسمالية من سحب البساط من تحت اقدام الاشتراكية العلمية من خلال تمكنها من تغيير طبيعة الصراع بين القوى الانتاجية "العاملين" وبين مالكي وسائل الانتاج "الراسماليين" وتحويله من صراع تناحري يدعو الى تغيير النظام الراسمالي الى الاكتفاء بمطالبه العاملين في مؤسسات ومصانع ومزارع الراسماليين الى تحسين وضعهم المعاشي وذلك برفع مستوى الاجور وتحسين شروط وظروف العمل من خلال تشريع بعض القوانين التي تعطي للعاملين بعض الامتيازات والحقوق السياسية مثل تحديد عدد ساعات العمل وتوفير التامين الصحي والضمان الاجتماعي والتقاعد والتعويض عن الاضرار الجسمانية التي تحصل جراء العمل وكذلك الحق في التنظيم في نقابات تدافع عن حقوق العاملين. هكذا قد تحول اتجاه نضال العاملين من السعي الى تدمير النظام الراسمالي الظالم القائم على اساس الملكية الفردية وبؤس وشقاء واستغلال العاملين الى النضال من اجل التعايش السلمي بين مشغلي وسائل الانتاج ومالكيها على اساس ضمان حقوق الطرفين بشكل متوازن على قدر الممكن وتقليص حجم الظلم والاستغلال الواقع على العاملين، وهكذا اصبحت العلاقة بين الجانبين علاقة جدلية قائمة على اساس ان كل طرف سبب وجود الطرف الاخر، ومصلحة كل طرف مرتبطة بضمان مصلحة الطرف الاخر. هذا النجاح الذي حققته الاشتراكية الديمقراطية في تحييد العنصر الثوري المحرك للصراع الطبقي داخل النظام الراسمالي وغيره من الاسباب الموضوعية والذاتية هي التي سببت في انهيار النظام الاشتراكي الدراماتيكي في الاتحاد السوفييتي واوروبا الشرقية دون ان يكون هناك من يدافع على بقاء واستمرار ذلك النظام، مع استمرار النظام الراسمالي في تطوره وتقدمه دون ملل او كلل.
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
||
|
|
|||